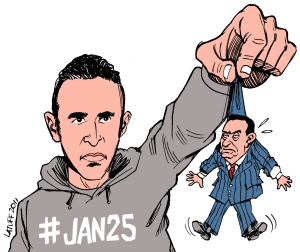7-10-2011
رائحة الناس في محطة نييس الفرنسية غريبة تذكرني برائحة سكان كوريا الجنوبية، ولكن هل للشعوب رائحة؟ مثلا لا أتذكر ما هي رائحة الشعب المصري رغم اني أعيش هناك أو ربما أنني تماهيت معهم فغدوت جزءا من رائحتهم..
هنا للناس رائحة قوية ربما لاحقا حين أقضي بعض الوقت اكتشف سبب الامر مثلما اكتشفت بعد شهور طويلة أثناء اقامتي في كوريا الجنوبية أن سبب رائحتهم هناك هي نوعية الطعام الذي يتناولونه فحتى الافطار مكون من اعشاب البحر “البنيمبوب” الملفوف بالارز والسمك النيء، لا يوجد دولة زرتها في حياتي اجمل من كوريا الجنوبية حتى هذه اللحظة!!، هي البلد الذي احن اليه دائما بعد غزة ..
الآن انا في محطة نييس الفرنسية عالقة بسبب اضرابات العمال، بعدما خرجتُ من موناكو متجهة لأزور اختي التي تعيش في كليرمونت..
أنفي أزكم من الرائحة هنا.. ليست كريهة بقدر ما هي غريبة كليا، هل معقول ان فرنسا ارض العطور الفاخرة يكون اول انطباع سلبي عنها يخص الرائحة، ربما كان محقا المؤلف باتريك سوزكيند حين جعل الرائحة في رواية “العطر” نكسة لأهل فرنسا..وربما كان القول الشائع أن الفرنسيين صنعوا العطور لأنهم لا يستحمون حقيقة !..نفضتُ الشكوى عن رأسي واشعلت سيجارة خارج المحطة علّها تبعد عني تلك الرائحة ولكن دون فائدة…
هنا اضرابات للعاملين وكذلك في مطار القاهرة و في وول ستريت بنيويورك، أشعر بالنعاس واريد ان أسب ولكني لا استطيع مع من يطالب بحقه فهم يضربون من اجل تحسين اوضاعهم من يدري من سيسب علي يوما اذا أضربت..”اضرب مع غيرك كي يضربون معك” يبدو أنه سيكون شعار الفترة القادمة…
قطاري تأخر، وعندي شعور أنه سيُلغى..قلقة.. وصرفت “الفكة” التي معي على التلفونات، فأختي تريد الاطمئنان علي رغم انها اصغر مني ولكنها تعاملني كأنني في العاشرة، وأنا أتفهم ذلك فهذه اول مرة لي بفرنسا وانا لا افقه شيئاً في لغتهم وهم لا يعرفون الانجليزية الا نادرا جدا جدا..إنهم فخورون بأنفسهم حد إصابتي بالغضب..
المغاربة يملأون المحطة وهم فقط من ساعدوني وباللغة العربية..نحاول الحصول على كوب شاي فمحطة نييس صغيرة ولا يوجد بها كافتيريات، اخذت ما معي من ماء وقصصت زجاجة بلاستك صغير لاصنع منها كوبا ووضعت كيسا من الشاي فانا احتفظ بأكياس الشاي لانها مجانية في غرفة الفندق، وهكذا شربت مع التونسيّن صدام وجمال الشاي وهما مثلي ينتظران القطار، وضحكت على اسمهما لأنها أسماء رؤساء عرب، فرد جمال انه انتهى زمن هذه الاسماء كرموز، والان زمن الانتفاضات والتغيير، فكرت كم أنتما متفائلين فان الاجهزة الامنية هي نفسها التي تعشش في دول الثورات، واكبر دليل على ذلك بلدكما تونس وحكيت لهما قصة عدم سماحي دخول تونس يوم 3-10-2011 بالاضافىة الى 11 مدون ومدونة، والسبب فلسطينيتنا، فأي ثورة هذه التي تأخذ وزارة داخليتها قرارا بهذه العنصرية؟! ناهيك عن المعاملة السيئة واجباري على توقيع تعهد في سفارة تونس بالقاهرة بألا أتجاوز مدة الفيزا رغم أني لم أكسرها في السابق مطلقا لأني لم أذهب في الأصل إلى تونس من قبل، وبالفعل انتهى مؤتمر المدونين العرب الثالث دون ان يشارك الفلسطينيون به لأن هناك اصرار ملح على عزلهم عن الربيع العربي كأنه مفترض علينا على الدوام فقط التفكير بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، لذلك فنحن خارج سياق التخلص من الحكومات الفاسدة رغم ان الكل يعرف كم نعاني من احتلال داخلي وحكومتين دكتاتوريتين بامتياز في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سكتُّ قليلاً لان حنجرتي تؤلمني من الحديث في السياسة كذلك يبدو ان صدام وجمال لا يفهمان لكنتي كثيرا، رجعت في تفكيري إلى إمارة موناكو التي خرجت منها قبل قليل متجهة الى نييس، وموناكو من اصغر دول العالم، وقد وصفتها لصديق عزيز يحب المدن أنها مثل قطعة الجاتو حلوة الطعم ورائعة المنظر ولكنها كثيرة على المعدة..بالفلسطيني “بتجفص”..
موناكو جميلة كمنزل كبير وسكانه لا يزيدون عن الـ30 الف، ما يعني أقل من عدد سكان مدينتي رفح.. موناكو محاطة بالجبال الخلابة..جوهرة مخبأة..ومدينة جميلة حد الألم وقد كنت هناك لتكريمي بصحبة المدون محمد الدهشان والذي كان يجب ان يكون اسمه محمد المدهش فهو يتقن ثلاث لغات والعديد من اللكنات ومن ضمنها الفلسطينية وذكي وطيب رغم انه يقول عن نفسه انه شرير، وسخر مني كثيرا لاني حين تصورنا مع امير موناكو ألبرت قلت للأمير اني اجمع أخباره وأخبار شقيقتيّه ستفاني وكارولين منذ كنت مراهقة وأوصيته بأن يسلم على شقيقتيّه، فذكرني الدهشان باالموقف لاحقا قائلاً: ” وقلتيله يسلم على الجيران وعماته واولاد المنطقة كمان؟”.. في الحقيقة الامير لحظتها ضحك وقال لي اتمنى ان يكون ما كنت تقرأيه اخبارا جيدة فأجبت بسرعة: “بالطبع بالطبع”، ولم أقل له أنها كلها عن اخبار علاقاته العاطفية ورومانسياته خاصة مع عارضة الازياء السمراء ناعومي كامبل.

ولم يكن ألبرت هو الامير او الشهير الوحيد الذي قابلناه أثناءاحتفال مؤسسة آنا ليند فهناك الفيلسوف الفرنسي الشهير أدغار موران والذي قال كلمة عميقة في الاحتفال عن الربيع العربي كذلك سفير موناكو للنوايا الحسنة والمستشار الخاص للملك محمد السادس أندريه أزولاي والذي قدمني بحفاوة أشعرتني بالخجل..!
ولا أنسى ذكر أننا حين كنا نتناول الغداء على شرف الاحتفال على سطح مبنى يطل على البحر الخلاب المليء باليخوت الفاخرة في منطقة مونت كارلو بموناكو، قلت لصديقة لبنانية أني اراهن أن المجموعة التي تجلس في الطاولة التي خلفنا من لبنان فملامحهم شرقية جدا ولم تستطع الفخامة والنظارات الشمسية تغطيتها، فقالت لي: “لا اظن”، دون أن تنظر، وبعد انتهاء الغداء انتبهت للطاولة، لتقول لي وهي مندهشة انهم ليسوا فقط من لبنان بل إن أحدهم بهاء الحريري الابن الاكبر للرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري…يبدو أن موناكو مستعمرة الأغنياء العرب..
أرجع إلى انتظاري في محطة نييس والساعات التي تمر فأنا لا اريد ان اتصل بالمنظمين مرة اخرى واخبرهم اني عالقة لانهم سيرجعونني الى موناكو فهي لا تبعد عن نييس اكثر من ثلث الساعة بالسيارة، لأني افضل خوض التجربة وحدي دون سند حتى لو اضطررت الى المبيت في المحطة، فأحيانا نحن لا نحب المدن الا بعد ان نتوه فيها.. كما أن عنوان المدن ليسوا الامراء وأفخر أنواع السمك والسيارات الغريبة في حداثتها..خاصة لابنة مخيم، فلا أرغب من السمك الجيد سوى زبدية جمبري عند مطعم ابو حصيرة..ولا يوجد عندي أجمل من سيارات أجرة المرسيدس الصفراء في شوارع القطاع..ففي العالم كله لا توجد سيارات أجرة مرسيدس سوى عندنا!!..
بدأ الصداع في رأسي …تائهة ..منتظرة..جائعة…لا أدري شيئاً..يبدو أني بدأت أتخيل الصداع وأتخيل التيه لكن ما هو حقيقي ان الاضراب مستمر واني لا أزال انتظر قطارا لن يأتي أبداً، وان الشاي طعمه سيء بالماء البارد، وأن تلك العجوز ذات الشعر الاحمر التي ترفعه كل لحظة والتي يبدو من ملابس تحملها في كيس قديم أنها دون مأوى هي مصدر الرائحة الغريبة..وليس للشعب الفرنسي رائحة غريبة..ولكني سأنتظر في الايام القادمة.. لن أستعجل الحكم!!..
8-10-2011
اليوم هو الثامن من اكتوبر وساقول لكم ما حدث بالأمس، لم أصل الى كليرمونت بعد..فقد خرجت من نييس بعد أن جاء القطار متأخرا 30 دقيقة ولكن حين وصلت مدينة ليون لم أستطع أخذ القطار إلى كليرمونت فقد تسبب الاضراب بإلغاء معظم القطارات ولا أزال بعيدة عن شقيقتي ما يزيد عن الـ 3 ساعات سفر.. شعرت بالغضب ..لاني كنت اعتقد ان تأخير قطاري في نييس اضاع علي الرحلة التالية حيث تغيير القطارات في ليون، لكني ارتحت حين عرفت ان السبب هو الاضراب، بَيّد أني ركضت مثل المجنونة طوال المحطة مع حقيبة سفر كبيرة،..فلا احد يعرف اللغة الانجليزية، وانا لا اعرف الفرنسية…
ومن ساعدني مجموعة من الافارقة السود فيبدو أن المهاجرين هم فقط من يحنون على بعضهم البعض وهم من اكتشفوا ان قطار كليرمونت تم الغائه بالكامل، شعرت بالضياع الكامل : هل سأنام في المحطة؟..لكن الجو البارد، هل اذهب الى فندق وانا لا اعرف شيئا في ليون؟..طمأنت نفسي واتصلت على شقيقتي من هاتف عام في الشارع، وقالت لي انها ستأتي وزوجها لأخذي من ليون بسيارة صديق لهما، ارتحت قليلاً، بعد حين اكتشفت ان المحطة حجزت لنا في فندق مجاور فأشفقت على اختي وزوجها أن يأتيا كل هذه المسافة خاصة أنهما يعملان في الصباح..فاتصلت بهما مرة اخرى وقلت لهما الا يأتيا وسأقضي الليلة في ليون.. ولأكمل التجربة حتى النهاية..
كنت اعتقد ان المصريين أكثر شعب في العالم يثير غضبي، ولكني كنت مخطئة بحقهم بعد ما تعرفت على الفرنسيين..الآن انا مخطئة بحق الاثنين..فغالبا ما ينبع غضبنا من الداخل ويعتمد على مزاجيتنا، صحيح ان البيروقراطية والسلوك العام في الدول العربية تثير الاستياء ولكن يصعب فصله عن سياق ظلم تاريخي أصاب الشعوب العربية..أوووف رجعت للسياسة..
ذهبت للفندق الذي حجزته إدارة محطة القطار لكل من أُلغى قطاره..ساعدتني فرنسية لطيفة عجوز وتدخن خارج المحطة السجائر في الوصول إلى الفندق، أعطيتها علبة سجائر “كِنت”..وكان معي في الحقيبة “كروز” سجائر كي اوفر على نفسي ثمنها الغالي في فرنسا ولكني اكتشفت انه قارب على الانتهاء فكلما ساعدني فرنسي لطيف اعطيته علبة من “الكروز” وذلك لا يدل على كثرتهم بل يدل على عدم تصديقي انك قد تجد من يساعدك في فرنسا..اعتذر اذا كان في كلامي تسرع ولكنها حقيقة انطباعاتي الاولى..
وصلت إلى الفندق وجلست أتصفح الفيس بوك وتويتر، وسعدت كثيرا بسماع أخبار ترشح صديقتي التونسية الرائعة لينا بن مهني لنوبل للسلام، فهذا الرد الحقيقي على من يحاربها في تونس بعد الثورة، وفرحت بنتائج الجائزة التي أُعطيت لثلاث نساء احداهن اليمنية توكل كرمان..تابعت مزيدا من الاخبار، ومن ثم ذهبت للنوم لأن هناك قطار في الصباح الباكر..
استيقظت في السادسة من صباح الثامن من أكتوبر وتوجهت حتى قبل تناول الافطار في الفندق لألحق القطار ولكنه كان قد ألغي بسبب اضرابات أخرى..انقبض قلبي وشعرت اني لن أرى اختي..نحن اهالي غزة تعودنا على اليأس السريع ..حجزوا لي في القطار التالي، فرجعت الى الفندق كي أفطر على راحتي ومن ثم رجعت الى المحطة وحفظت شكل الشاشة الاكترونية وأمكنة الارصفة كي لا أضطر لسؤال اي فرنسي في حياتي..والان انا في القطار وهناك منقبة في القطار، رغم قانون حظر النقاب وشعرت بشجاعتها انها ترتدي نقاباً رغم القرار العنصري الذي اتخذته فرنسا، وهذا لا يتناقض مع رأيي الشخصي الرافض لنقاب المرأة، لأنه ليس من حق الدولة أن تفرض على أفرادها ما يناقض حرياتهم الشخصية، فالدولة العلمانية تخلق مناخا مدنيا لتعايش جميع الأديان مع بعضها ولا تُقصيها..
الان انا متجهة الى اختي وهناك محطة تبديل في احدى المدن الصغيرة، واتمنى من كل قلبي الا يتم تأجيل أي شيء والا سيكون معبر رفح ومصاعبه افضل بكثير من محطات قطار فرنسا كلها..!!
بعد ساعات طويلة في القطار أخيراً وصلت إلى محطة إحدى المدن التي تحمل اسما فرنسيا طويلا ومن هناك كان المفترض أن آخذ قطارا الى كليرمونت ولكن استمرار الاضرابات حرمني من ذلك، وكي لا تتحمل المحطة تكاليف اقامة في فنادق من جديد جاءت لنا إدارتها بحافلة مرت على كل القرى قبل أن نصل الى المدينة الموعودة وكانت اختي بانتظاري منذ فترة في محطة كليرمونت فقد تأخرتُ حوالي الساعة..

حضنتني وحضنتها ومن ثم أخذتني الى منزلها القريب وطبعا ظَلّلتنا الاحاديث والموسيقى العربية والاجواء الجميلة والغذاء الاجمل في البيت الصغير التابع لسكن طلبة ولكنه جميل وسرعان ما جاء زوجها ومجموعة من الأصدقاء وخرجنا لنشرب القهوة في ساحة “جود” وهناك رأيت كنيسة كليرمونت المبنية من حجر اسود بركاني ذكرتني بكنيسة كولون الشهيرة بألمانيا..

وكان غريبا علي قليلا ان ارى الكنائس الضخمة في مكان العلمانية فيه تحمي مفهوم الدولة من الدين وهو عكس ما يحدث في امريكا مثلا التي تطبق علمانية تحمي الدين من الدولة، ولكني فكرت أن الاماكن الدينية هنا أصبحت جزءاً من التاريخ والسياحة بالضبط مثلما البوذية في كوريا الجنوبية فرغم أنه الدين هناك إلا أنه اصبح دينا سياحيا اكثر منه حيويا بين سكانه، فالمعظم في كوريا تحولوا للمسيحية فهي ثاني دولة في العالم من ناحية كثافة تواجد البعثات التبشيرية فيها.
وزرت أيضا في اليوم ذاته ساحة النصر بكليرمونت ورأيت تمثال أوربان الثاني وهو يشير بيده الى الشرق حيث أمر أولى الحملات الصليبية بالتوجه، ولحظتها قلت لأختي مازحة: هل أتوقع أي شيء عنصري بحقي في هذه المدينة؟، وبالطبع لم يكن الامر صحيحاً فقد لاحظت فكرة مسبقة عنصرية باتجاه الافارقة وليس العرب أو المسلمين وهذا امر لاحظته في كل مكان وليس فقط في فرنسا، لا ادري لماذا كل شيء يتعلق بلون البشرة ؟ ففي الحافلة التي انطلقت بي للقاء اختي في كليرمونت كان الكرسي الذي بجانب الافريقي هو الوحيد الفارغ في الحافلة، وبالطبع جلست بجانبه، لاني لا انسى انهم من ساعدوني، فالفرنسيين حتى لو عرفوا الانجليزية لن يساعدوك، ولا ادري الى اي حد انطباعاتي صحيحة..

انا حساسة اتجاه المدن الى درجة كبيرة لدرجة اني شعرت أن كليرمونت ليست ذات شخصية كمدينة إلا في نظام إشارات المرور فبين كل اشارة واشارة هناك اشارة وثلاثة طرق فرعية كبيرة رغم ان المدينة فعليا تكاد تكون فارغة..
ومن تمثال أوربان الثاني إلى شرب القهوة التي لا أزال احاول اكتشاف اذا كان هناك ما يميزها في فرنسا ام لا؟ ذهبنا الى مركز تسوق كبير وأخذ زوج اختي عربة تسوق يبحث عن انواع الاسماك والاجبان والخضروات ليصنع لنا سلطة من السلمون وبالفعل استمتعنا بالتسوق كما استمتعنا بالطعام وتذوق أنواع الجبن الغريبة والكثيرة ..
وحين وصلنا وبدأنا بتحضير العشاء تشاجرنا “تقريبا ” اذا كنا سنضع على السلطة بصل وطحينة ام لا؟، فيبدو أن هذه المواد تصنع الفارق بين السلطة الاوروبية والشرقية..في النهاية انتصرت اوروبا..
نمنا متأخراً بعد سهرة ضحك وثرثرة في المطبخ الذي هو أكبر من البيت ..وكان علي ان انام في غرفتهما الوحيدة وذهب زوج أختي للنوم في بيت صديقة الطبيب يوسف وهو سوري كردي رائع بكرمه، وبالطبع في آرائه السياسية فهو معارض عقلاني واخذنا نتحدث عن برهان غليون وحوار “الفضيحة” مع احمد منصور على “الجزيرة” والذي صادف ان شاهدته وانا بموناكو..إن المفكرين الكبار مثل عمرو حمزاوي وبرهان غليون يخسرون الكثير بتحولهم الى السياسة وتتبع طموحهم السلطوي..فلا يرجعون للفكر ولا يمسكون بزمام السياسة، وفعل هذا من قبلهم عالم الدين احمد الكبيسي الذي أسس حزبا في العراق واختفى عن الساحة كمفكر اسلامي تنويري مميز..
وبالطبع لكل عربي هناك معاناة فالدكتور يوسف لا يستطيع ان يرى ابنه الذي في روسيا لانه حين ارسل جوازه للسفارة السورية في فرنسا كي يتم تجديده تم حجزه، رغم انه كان على وشك السفر واشترى لابنه كل شيء يريده من العاب وقصص، ولكنه لم يسافر، وابنه لا يستطيع القدوم لفرنسا لان والدته المنفصلة عن والده ترفض ترك روسيا حتى لأشهر قليلة، أية معاناة وحزن وأية روح لا تزال متفائلة وفرحة يتمتع بها د. يوسف رغم كل الالم..
نمت وانا افكر في كل هذا، وابتسم حين تذكرت انه من روعة السلطة على العشاء يبدو اني حسدتها فانقلب الصحن في حضني قبل ان آخذ منه لقمة واحدة وطبعا اختي نصف ساعة وهي تضحك والبقية يلتقطون الصور وانا ادعو في رأسي أن يكون طعمها لا يزال صالحا وبالفعل كان صالحا، واكلتها, الا ان نومي كان متقطعاً ومليئا بالكوابيس ولولا شقيقتي بجانبي لاختنقت..

9-10-2011
صباح اليوم التالي كان بردا ومطرا..وفيروز تغني وانا لا استطيع القيام من السرير بسبب البرد الشديد ولكنني طبعا اخاف من غضب شقيقتي فقمت أركض، ورأيت على طاولة المطبخ كورن فليكس، فاستغربت قليلا، أليس هذا فطورا امريكيا بامتياز لكني سكتُ فليس غريبا بعض الامركة الفرنسية -فقد رأيت فرعا لماكدونلدز في فرنسا وكان مكتظا- ولكن بالطبع كان على الطاولة الكورسون الفرنسي بعجينة اللوز الرائعة والزبدة والاجبان، بَيّد أني أكلت صحن الكورن فليكس توفيرا للسعرات الحرارية، وفيما بعد عرفت من زوج اختي أن من يصر على شراء الكورن فليكس هي اختي فيبدو انها لا تزال متأثرة بتربية الامارات!.
ومن المعروف عن الفرنسيين أن الحلويات والسكريات تملأ مائدة افطارهم، وأتخيل أنهم سيجفون لو أكلوا شيئاً مالحاً..
كان صباحاً جميلا وكتبت على الفيس بوك انه صباح فلسطيني فرنسي بامتياز مع الكروسون والبرد والنافذة التي تطل على الجبال الخضراء ..هذا الجانب الفرنسي اما الفلسطيني فيتجلى في فيروز والغضب العائلي الصباحي :>..
بعدها خرجنا وتمشينا واخذنا حافلة الى سوق الاحد الذي يبيع الاشياء القديمة ويا إلهي ما اجمله، رائع باللوحات والالعاب والاكسسوارت والملابس وكل شيء جميل ومُجدد، ونادرا ما تجد ما يزيد عن الاربعة يورو، وامطرت ونحن نتمشى في السوق وهو عبارة عن مئات البسطات في ساحة كبيرة جميلة واشتريت بعض اللوحات القديمة والالعاب والاحذية الجلد والجاكيتات الشتوية، وطبعاً اصبح وزن الحقيبة مضاعفا، وعرفت الان حين يذهب الناس الى فرنسا لماذا يستمرون بالقول “تسوقنا في باريس” فهذا هو السوق السري للعرب -أو الطبقة المتوسطة منهم- وهو سوق موجود في كل مدينة فرنسية..
بعد السوق عرفتني أختي على الطبيبة السورية وداد وبصراحة لم نتكلم عن السياسة لاني كنت سمعت من قبل أن عندها وجهة نظر مختلفة في الثورة، ورأيت انه لا يجب ان نختلف خاصة انها كانت رائعة معي وانا اخسر الناس في غالبية الاحيان بسبب النقاش السياسي او الديني، وقد عزمتني على غذاء في مطعم فرنسي يوجد على قائمته لحم الكنغر!!، طلبت اختي سمكاً وأنا طلبت قطعة ستيك وأكدت على أهمية طهيها جيدا الا انها كان من الداخل شديدة الاحمرار الامر الذي جعلني اتأمل الطعم أكثر من الاستمتاع به خاصة أن وداد قالت لي ان الفرنسين ذواقة في اللحوم، وطلبت هي دجاجا مكسيكيا بالخبز الاسباني، بعدها ذهبنا الى منزلها الذي كان جميلا وصغيرا ومليئا بالاوراق التي تدل على كم هي غارقة بالشغل والابحاث الطبية، وساعدتنا كثيرا كي نحجز للذهاب الى باريس ليس عبر القطار بل عبر الـ”كوفوتوراج” والمعنى الحرفي هو النقل المشترك، ولأشرح اكثر فهناك موقع على الانترنت لكل اوروبا يسجل فيه كل من يرغب في اخذ ركاب معه بسيارته وهو متجه الى اي مدينة اوروبية وتكون بأقل من نصف ثمن تذكرة القطار، وبحثنا عن باريس ووجدنا عشرات الخيارات وتعليقات الناس تحته الذين ذهبوا مع نفس السائق، وهل هو جيد في الطريق أم لا؟، ووجدنا أحدهم متجه الى باريس واسمه كريم وعنده مكانين فارغين وهناك 17 تعليقا كلها ايجابية عنه وعن سواقته، وبـ25 يورو للفرد..
وايضا بحثنا بمساعدة وداد عن احدهم متجه الى بلجيكا من باريس كي نزور شقيقنا مصطفى، واستغربت مدى رواج هذه الطريقة بين سكان أوروبا والثقة والوضوح التي يتمتع بها الناس بين بعضهم البعض، فتخيلوا لو ركبتم بهذه الطريقة في دولة عربية، كم سيكون هناك من الخوف وعدم الثقة؟ ناهيك عن سوء سمعة هذه الطريقة في السفر، لكن في أوروبا الأمور واضحة وطبيعية فهو ليس سائقا كي نعامله بدونية، كما أنه لا يستغل الركاب بطلب المزيد من المال.. بل هناك تكافؤ بين جميع من في السيارة فالسائق يعوض ما يخسر من بنزين ورسوم دخول المدينة التي تزيد احيانا عن الـ30يورو أما نحن فنوفر المال والوقت ونخوض تجارب مواصلات لا تنتمي للرأسمالية الباردة…
بعد منزل وداد اتصل د.يوسف واخذنا بسيارته لنرى مدينة “فيشي” وما اجمل مدينة فيشي وشعرت للوهلة الاولى ان لها شخصيتها الواضحة وهي المدينة الوحيدة التي تفتح محالها يوم الاحد، وفيها ينابيع فيشي الشهيرة التي تأتي مياهها من الجبال الفرنسية لتصب في هذه المدينة الصغيرة، وقبل أن أرى الينابيع الساخنة تخيلتها مثل التي كانت في مدينة العين في الامارات على جبل حفيت المفتوحة للعامة للاستمتاع وللسباحة، ولكن هذا ليس بفرنسا فكل الينابيع مغطاة بغطاء زجاجي كأنها مرطبان ضخم، وهناك صنابير في كل مكان وكل صنبوبر مكتوب عليه اسم الجبل التي تنزل منه المياه، والمياه مالحة او بالأحرى ليست مالحة بقدر ما هي لها طعم الحديد والماغنيسيوم …

ومدينة فيشي غنية بملابس وبضائع الماركات العالمية حتى المنتجات الموجودة على البسطات فكل شيء غالي بشكل جنوني والتخفيضات تعني نصف الثمن، ونصف الثمن في الغالب لا يقل عن الـ50 يورو، لذلك لم أفكر بشراء شيء، حتى لمحت شقيقتي امرأة تبيع جاكيتات ماركة “إيتام” وثمن الجاكت بـ80 يورو، الا ان التخفيضات على الجاكت بـ25 يورو شجعتنا على شرائه.
وقبل ترك فيشي وشأنها لا يجب أن أنسى ذكر أن حكومة فيشي-حسب مصادر تاريخية فرنسية- تمتعت بسمعة سيئة في بداية أربعينات القرن الماضي حين اتخذها هتلر مقرا له في فرنسا كحكومة عميلة موالية، وساعدته على تطبيق أوامره بسجن اليهود وإرسالهم للمحارق وكذلك ساعدته على محاولات احتلال فرنسا الحرة وبسط نفوذه لمدة تزيد عن الأربعة أعوام حتى حررها شارل ديغول….
ولأيام التيه في فرنسا بقية
أسماء الغول-فرنسا